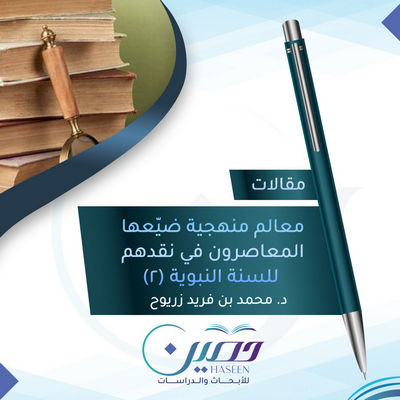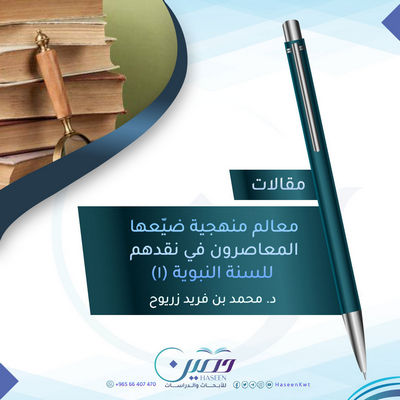بقلم: إبراهيم بن محمد صديق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المُنْعِم علينا بالإسلام، والصَّلاة والسلام على سيِّد الأنام محمَّد بن عبد الله، وعلى آله وصحبِه ومن تبعهُم بإحسان، أما بعد:
فإنَّ من يقرأُ التَّاريخ منذ ظهور الإسلام إلى يومِنَا هذا يجدُ كثيرًا من أصحاب المناصبِ العالية والمكانات السَّامِقة قد غيَّروا دينهم إلى دين الإسلام، وذلك منذُ عهد النبي ﷺ كما فعل عبدُ الله بن سلام الذي كانت له المكانة العليا في اليهود، حتى قالوا عنه: «هو أعلمُنا وابنُ أعلمنا، وأخْيرُنا وابن أخيرنا» صحيح البخاري (٣٣٢٩) (١) ، وكما فعل النَّجاشي وهو ملك الحبشة، وغيرهم ممن تركوا أديانهم إلى دين الإسلام رغم عزَّتهم قبل الإسلام وجاهِهم ومكانتِهم؛ بل تخلَّى كثيرٌ منهم عن تلك العظمة والجاه والمكانة حتى يدخلوا في هذا الدين، وهم قد رأوا في الأرض عشرات الديانات والمعتقدات تتلاطمُها أمواج عقول البشر في الدُّنيا؛ لكنّ نفوسهم لم تسكُن إلا إلى هذا النُّور السَّاطع الذي أشرق وسط ركام الظَّلام والجهل والشِّرك والوثنية، والذي تمسك به هؤلاء وأمثالهم حتى يرتقوا من مُنحدَرِ الوثنيَّة التي هم فيها، فلماذا اختاروا دين الإسلام وسكَنت نفوسهم إليه بالرغم من وجود كلِّ هذه الأديان؟ وهل يمكن أن نجزم بأنَّ الإسلام هو الدينُ الحقُّ دون أن نختبر الأديان الأخرى؟ أليس على الإنسان أن يختبر بعقله كل الأديان حتى يصل إلى الدِّين الصحيح؟
وقبل أن أجيب عن ضرورة البحث عن صحَّة كل الأديان من عدمها، أقول:
إنّ طبيعة الأديان تُحتِّم وُجودَ موضوعاتٍ أساسيَّةٍ في كل دين، كالمعبود، والتشريعات، والأخلاق، ومن تأمَّلَ هذه الموضوعات في دينِ الإسلام وجدَ أنَّها جاءت فيه على أعلى درجات الكمال، ممَّا يجعل الإنسان متيقِّنًا بصحَّة هذا الدّين، ثمَّ بمقارنته بغيره من الأديان في تلك الموضوعات يظهرُ تفرُّد الإسلام بكونه الدِّينَ الحقَّ الذي يجب اتباعه، مع وجود عشرات الأدلَّةِ الأُخرى على صحّة الإسلام.
فالإسلام - لمن تأمّله - هو الدِّين الوحيد الذي يتَّفق مع كلِّ ما ينبغي أن يكون عليه الدينُ الصَّحيح؛ من وجود تصوُّرٍ صحيحٍ للإله المعظَّم الذي له الكمال المطلق، ومن وجود تشريعاتٍ غيرِ متناقضة، محقِّقةٍ لمصالح الإنسان وحاجاته الروحية والاجتماعية والاقتصادية، ومن اتِّساقٍ مع العقل دون مناقضَةٍ له.
والأدلَّة على صحَّة الإسلام كثيرة، وهو من بينِ سائرِ الأديان يحمل أدلة صحَّته في نفسه، وفي رسوله، وفي كتابه؛ أمَّا أدلّته في نفسه فلدينا عشرات الأدلة، مثل: اتّساقه، وعدمِ تناقُضه، وكمالِ ما يدعو إليه.
وأما صحَّة كون النبي ﷺ رسولًا من ربِّ العالمين فلدينا أيضا عشرات الأدلة الدالة عليه؛ سواء كانت الأدلة في صفاته، كصدقِه وأمانتِه وأخلاقِه وكونِه أميًّا أتى بهذا القرآن المعجز، أو كانت فيما جاء به وهو القرآن الكريم والدين الإسلامي، أو في نصرته لله له ولدينه.
وأمَّا ما يتعلق بكتابه، فالأدلة كثيرة أيضًا على كونه من رب العالمين، أنزله الله ليخاطب البشرية ويدعوهم إلى اتباعه، وذلك مثل: كونِهِ مُعجزًا في بلاغته ومعانيه، وكونِه حاويًا لأخبار الأمم السابقة ممَّا لا يمكن للنبي ﷺ أن يَعْلَمه من تلقاء نفسه، وكونِه مخبرًا بمستقبَلٍ قد ظهر صدقه، وغيرها من الأدلة.
وتفصيل كل دليلٍ مما سبق يستدعي بسطًا وتوسُّعًا، لا سيّما المتعلّق منها بالنبي ﷺ والقرآن، مما قد صنّف فيه أهل العلم قديمًا وحديثًا، وإنما يقصد هذا المقال إلى الإلماح إلى المعالم الأساسية، الدالّة على صحة الإسلام في نفسه، وذلك فيما يلي:
أولًا: الإسلام يقدّم التّصور الكامل عن الإله المعبود:
معظم الأديان تقدِّم تصورًا عن المعبود لديها، إلا أنَّ أكمل صورة وأعظمها هي تلك الصُّورة التي قدَّمها الإسلام للإله المعبود، فالإسلام بنصوصه يقدِّم صورة عظيمةً للإله، وكلُّ تصور آخر له في أيِّ دينٍ من الأديان هو تصوُّرٌ يشوبه الكثير من التنقُّص لذاتِ الله سبحانه وتعالى.
فالإسلام يقدّم في نصوصِه صفاتِ الله سبحانه وتعالى بطريقةٍ واضحة جليَّةٍ لا غموض فيها، بل هي قريبةٌ من العقل، وبسيطةٌ في الفهم، ومتوافقةٌ مع الفطرة، ومن تلك الصفات التي قدمها الإسلام عن المعبود:
١) الوحدانية، فالله هو الأحد الذي لا يشاركه شيءٌ، لا في الوجود، ولا في التَّدبير، ولا في الخلق، ولا في الكمال، كما قال تعالى: قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص: ١]، فهو الواحدُ الذي يجبُ أن تُوجِّه كلُّ المخلوقات قلوبَها إليه، وأن تُفرِده وحدَه بالعبادة، فـ «لا نظيرَ له ولا وزير، ولا نديدَ ولا شبيه ولا عديل، ولا يُطلق هذا اللَّفظُ على أحدٍ في الإثبات إلّا على الله عز وجل؛ لأنَّه الكامل في جميع صفاته وأفعاله» تفسير ابن كثير (٨/ ٥٢٧-٥٢٨) (٢)، فالله في الإسلام واحد، فلا ثَنَويَّة تُناقض اتِّساق الكون وانضباط قوانينه، ولا هو مركَّبٌ من أقانيم ثلاثة كما تقدِّمه النصارى، ولا هو أدنى من العِباد فيكون حجرًا أو شجرًا لا تملك لأنفسها ضرًّا ولا نفعًا.
٢) القدرة المطلقة، فالله هو القادر على كلِّ شيء، الفعَّالُ لما يريد، الذي خلق كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا [الفرقان: ٢]، فكل المخلوقات دقيقها وجليلها دالَّة على القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى.
٣) العلم، فهو لا يغيبُ عنه مثقالُ ذرَّة في الأرض ولا في السماء، وهو يعلم مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ [الأنعام: ٥٩].
فالمعبود في الإسلام كَمُل بصفاته، «بل الثَّابت له هو أقصى ما يمكن من الأكمليَّة، بحيثُ لا يكون وجودُ كمالٍ لا نقصَ فيه إلا وهو ثابتٌ للرَّبِّ تعالى، يستحقُّه بنفسه المقدسة» الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال (ص:٧) (٣)، وكل صفةٍ من صفات الله المذكورة في القرآن والسنة فهي تدلُّ على أعلى درجات الكمال لله سبحانه وتعالى.
وهذا التصور الذي قدمه الإسلام عن المعبود هو الذي ينبغي أن يكون التصور الصحيح، لأنه تصورٌ كاملٌ عن إله كامل، وبمقارنة الإسلام بغيره نجد أنَّ غيره من الأديان والأفكار لم يقدِّمْ تصوُّرًا عن المعبود، أو أنَّه قدم تصورًا ناقصًا، فإمَّا آلهة متعددة متناحرة، أو إلهٌ مركَّب من ثلاثة آلهة هي إلهٌ واحد! أو إلهٌ ينزل إلى رحم امرأةٍ فيولد كما يولد الأطفال، ثم يُؤخذ ويُصلب ويموت ويُدفن ويقاسي كلَّ هذا العذاب على أيدي خلقه، بل نجد بعض الأديان كاليهودية والنصرانية تُصوِّرُ الإله بصفات نقصٍ لا تليق حتى بالبشر، فهو إلهٌ يحزن ويتأسَّف سفر التكوين (٦/ ٦) (٤)، ويندمسفر الخروج (٣٢/ ١٤) (٥) ويتعب ويستريحسفر الخروج (٣١/١٧) (٦) بل ويصارع ويُغلب!سفر التكوين (٣٢/ ٢٣-٢٩) (٧). فالإله في تصورات الأديان لا يرقى لأن يكون إلهًا يُوحَّد ويفرد بالعبادة، أمَّا الإسلام فهو الدين الوحيد الذي قدَّم تصوُّرًا صحيحًا للإله المعبود الذي يستحق أن يُعبد.
ثانيًا: الإسلام هو دين التَّوحيد الصافي:
التَّوحيد هو المتَّسق مع العقل، فهذا الكونُ الفسيحُ وقوانينُه المنضبطة يدلُّ على خالقٍ واحد، وهو وحده يستحقُّ العبادة، فتعدُّد الآلهة ممَّا يقدح في الدين عقلًا، ومع كثرة الأديان الموجودة إلا أنَّ الإسلام هو الدِّين الوحيد الذي نادى إلى التوحيد وبقيَ على صفائه ونقائه، ووَضَع السِّياجات المنيعة للحفاظ عليه.
وقد أمر الإسلام بالتَّوحيد، وضرب له الأمثلة في القرآن الكريم، وذمَّ الشِّرك والمشركين، ونبذَ التعلُّق بغير الله، فأيُّ دينٍ يقدم عقيدةً كهذه، تجعلُك تتعلق بالله وحده؟
ويتجلَّى جمال الإسلام وعظمتُه في أنْ جعل المسلم عزيزًا بدينه، وعزيزًا بعقيدته، لا يخضع لأحد إلا لله سبحانه وتعالى.
ولو نظرنا إلى الأديان الأخرى نجد أنَّها لا تحقق التوحيد الخالص، بل إنَّ أكثرَ الأديان تدعو إلى عبادة غير الله والشرك به، وتُعلِّق الإنسان بغير الله كالرُّهبان والقدِّيسين، فتترك بأيديهم مفاتيحَ الجنة والنار وصكوك الغفران، وفي كل ذلك إخضاعُ النَّاس للناس، بينما الإسلام يُخضِعُ النَّاس لربِّ الناس.
ثالثًا: نظرة الإسلام للأنبياء:
من كمال الإسلام وعظمته أنَّه هو الدين الذي يحتِّم على معتنقيه الإيمان بالأنبياء كلِّهم، فلا يكتمل إيمانُ الإنسان إلّا إذا آمن بجميعِ الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمَّد ﷺ، ولا يجوز للمسلم أن يفرِّق بين نبيٍّ وآخر فيؤمن ببعضهم دون بعض، يقول تعالى:
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ [النساء: ١٥٠-١٥١].
كما أنَّ الإسلام يدعو إلى عدم تنقُّص أحدٍ من الأنبياء، ويوجب احترامَهم جميعًا، ونسبةَ الكمال إليهم، فالإسلام في هذا الجانب يختلف عن اليهوديَّة والنصرانيَّة في إيمانهم بمن آمنوا بنبوّته مع تنقّصه، فإن َّكتب الديانتين مليئة بتنقُّص الأنبياء، ونسبةِ العُيوب إليهم، واتِّهامهم بأمورٍ لا يمكن أن يرتكبها إنسان سويٌّ فضلًا عن أن يرتكبها نبيٌّ، فقد نسبوا إلى نوح عليه السَّلام شربَ الخمر والتَّعرِّيسفر التكوين (٩/٢٠- ٢٤) (٨)، وإلى لوطٍ عليه السلام الزِّنا وشرب الخمرسفر التكوين (١٩/٣٠-٣٨) (٩) وإلى يعقوب عليه السلام المكْرَ بأبيه والكذب عليهسفر التكوين (٢٧/١٨-٣٠) (١٠)، إلى غير ذلك ممَّا نِسْبَتُهُ إلى الأنبياء كفرٌ في الإسلام، ولا يستقيم مع حكمة الله الذي اصطفاهم، ومع كمالِه في أحكامه.
رابعًا: كمال التَّشريعات:
التَّشريعات التي قدَّمها الإسلام هي في أعلى مراتب الحُسن والجمال، فأينما وجَّهت بصرك في تشريعات الإسلام رأيت الكمال والمصلحة المحقَّقة، فقد أمرت الشَّريعة بكل حَسَن، ودعت إلى كلِّ فضيلة، ونهت عن كل رذيلة، وحثَّت الأمة على محاسن الأخلاق، وجميل الآداب.
وقد حرصت الشريعة على التَّنوع والشمولية، فشرعت عباداتٍ وأحكامًا تخصُّ الإنسان وحده كالصَّلاة والذكر، وعباداتٍ تخُصُّ علاقتَه بغيره كالزّكاةِ والإحسانِ والبرِّ، ومنها ما يُنمِّي الإخلاصَ وعدمَ الرّياءِ كالصَّوم وأعمالِ القلوب من خوفٍ ورجاء وحبٍّ وخَشية، ومنها ما ينمِّي التَّرابطَ بين جماعةِ المسلمين كالحجّ، ومنها ما تكون فائدتُه للفَرد خاصَّة، ومنها ما تكون فائدتُه للمجتمَع.
وإذا نظرنا إلى جانب النَّواهي نجد أنَّها حافظة للفرد والمجتمع من مهاوي الانحلال، وكل تلك المحرمات لم تكن لذاتها فحسب؛ بل هي راعيةٌ ومحافظة على مقاصد الإسلام؛ فمنها نواهٍ لحِفظِ الدِّين؛ كتحريمِ الاستهزاء بالدّين ومُجالسةِ من يشكِّك فيه، أو لحفظِ النَّفس؛ كتحريم القتل والاعتداء، أو لحفظ العَقل؛ كتحريم الخمر والمسكرات، أو لحفظِ المال؛ كتحريم السَّرقَةِ والربا، أو لحفظِ العِرْض والنّسل؛ كتحريم الزنا والفواحش.
خامسًا: اتِّساقُه مع العقل:
الله سبحانه هو خالقُ العقل، وقد جعل له مجالَه في التفكير والإبداع، ومن كمال الشَّريعة أنَّها لا تناقض العقل، فمن تأمَّل عقيدة الإسلام وتشريعاته ومبادئه وأخلاقيَّاته اتَّضح له أنَّ الإسلام متَّسقٌ تمامًا مع العقل السّليم.
ثمَّ إنَّ الإسلام هو الذي يزكِّي العقل ويوجِّهه لا العكس؛ فالعقل محتاجٌ إلى الوحي دائمًا ليسير بالشَّكل الذي أراده الله منه، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: «المؤمنُ قلبه مضيءٌ يكادُ يعرف الحقّ بفطرته وعقله، ولكن لا مادَّةَ له من نفسه، فجاءت مادَّةُ الوحي فباشرت قلبَه وخالطت بشاشته، فازداد نورًا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نورُ الوحي إلى نور الفطرة»الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: ٥٣) (١١)، فالعقلُ يهتدي بنور الشَّرع، والشَّرع لا يناقض العقل، وأمَّا سائر الأديان فغارقةٌ في التَّناقضات العقليَّة، وكُتُبُ هذه الأديان مليئةٌ بالمغالطات والأخطاء العقليَّة والعلميَّة، فالنصرانية -مثلًا- تؤمن بأنّ المسيح هو ابنُ الله وهو الله، وتؤمِن بالثّالوث الذي هو واحدٌ وثلاثة في آن واحد، وقد اعترف بعدم عقلانية التثليث جماعةٌ من قساوسة النصارى أنفسهمينظر: الله واحد أم ثالوث، لمحمد مجدي مرجان (ص: ٥٨) وما بعدها (١٢)، فلا يوجد دينٌ متكامل مع العقل إلا الإسلام.
سادسًا: حفْظُ نصوصه:
لا يوجد اليومَ دينٌ محفوظٌة جميعُ نصوصه الأصليَّة سِوى الإسلام؛ ذلك لأنَّ الله تعهَّد بحفظه فقال: إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ [الحجر: ٩]، وقد مرَّ أكثرُ من أربعمائة سنة وألف والقرآن لا يزال كما هو بحروفه وحركاته، وأقدم النُّسخ التي اكتُشفت تثبت أنَّه لم يطرأ عليه أيُّ تغيير، بل حُفظت أقوالُ النبي ﷺ وأفعالُه وتقريراتُه وحركاتُه وسكناتُه؛ فحِفظ السنَّة من حفظ القرآن لأنَّها مبيِّنةٌ وموضِّحةٌ له.
والحكمة من حفظ الله للقرآن دون سائر الكتب أنَّه كتاب الشريعة التي جاءت خاتمةً للشرائع كلِّها، فلا مبدِّل لها، ولأنَّها شريعةٌ عامَّة لجميع المكلَّفين من بعثة النبي ﷺ إلى قيام الساعة.
في حين أنّنا نجد الكتاب المقدس الذي هو كتاب اليهود والنصارى لا توجد نصوصه الأصلية؛ بل جميع النُّسخ التي وجدت كان تاريخها بعيدًا عن زمن أنبيائهم؛ ولذا نجد الاختلافَ الكبير بين النُّسخ الموجودة بين أيديهم اليوم.
دينٌ واحد فقط:
بناء على ما سبق بيانه فإنَّ الدين الصَّحيح هو دين الإسلام، ولا يمكن أن يقال: كلُّ الأديان حقّ، أو كلُّها موصلةٌ إلى الله؛ بل هذا القول قولٌ متناقض، إذ لا يمكن الجمع بين عقيدة التَّوحيد التي تجعل الإله المعبود واحدًا وبين عقيدة التَّثليث أو الوثنيَّة، ولا يمكن الجمع بين تصديق نبوَّة محمَّد ﷺ وبين تكذيبه، ولا يمكن الجمع بين الإيمان بوجود الله وبعدم وجوده، فهذه أفكارٌ متناقضةٌ لا يمكن أن تكون كلها على حق، والقول بأنَّ كل الأديان صحيحة فيه جنايةٌ على العقل البشري، فالعقل السليم لا يمكن أن يرضى بالمتناقضات.
فالدينُ الوحيد الذي يصحُّ هو دين الإسلام، وتصحيحُ أيِّ دينٍ آخر هو إبطالٌ للقول بصحَّة الإسلام، وقد قال الله تعالى:إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ[آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ [آل عمران: ٨٥].
ولا ينبغي للمسلم الالتفاتُ إلى من يريد التَّشغيب على الإسلام، أو التنقُّصَ منه، أو بثَّ الشُّبهات حوله، بل عليه أن يتيقن أنَّه على الدين الحق، وأنَّ في الالتزام به النَّجاة، وأنَّ كلَّ الأدلة الصحيحة تدلُّ على صحته.
الواصل لا يبحث عن الطَّريق:
إذا تقرَّرَ أنَّ الإسلام هو الدِّين الصَّحيح المقبولُ عند الله، وأنَّ كلَّ ما سواه باطل، فإنَّه إذا وصل الإنسان إلى الإسلام، أو نشأَ عليه فقد كفاه، ولا يجبُ عليه أن يبحث عن بطلان كلِّ الأديان الأخرى، لأنَّ الوصول إلى الحقِّ هو الغاية، ومن حقَّقها لم يُطلَب منه التَّحقُّق من كلِّ الطُّرق.
أرأيت لو أنَّك أردت يومًا أن تذهب إلى وجهةٍ ما ثم وجدت أمامك عدَّة طرق لا تعرف أيُّها الصَّحيح المؤدي إلى وجهتك، فأخبرك أحدُهم بالطَّريق الصحيح فسلكتها حتى وصلت، فهل يكفيك الوصول؟ أم ستظلُّ تبحث في كلِّ طريقٍ وتختبرها وترى فسادها وأنَّها لا تؤدي إلى وجهتك؟
لا شكَّ أنَّ كلَّ عاقلٍ يقول: تكتفي بالوصول، ولا تهمُّك الطرق الأخرى ووجهاتها ما دُمت قد وصلت، وهكذا هذا الدِّين الذي تعتنقه أيُّها المسلم، فإنّ من خَطَل الرَّأي أن يُقال: يجب اختبارُ جميع الأديان دينًا دينًا ومعرفةُ فسادها حتى تعرف أنَّك على الحقّ، فهذا مجرد كلام مأزومٍ لا قيمة له في الميزان العلمي، بل لا يتعامل به أهل الدنيا في صِغار الأمور، فكيف بالدِّين الذي يعتنقه الإنسان طوال حياته؟ فهو مثل تلك الطريق التي أوصلتك دون معرفةِ الطُّرق الأخرى، وهو -كذلك- مثل أن تأتي إلى بابٍ من الأبواب المُغلقة، وبين يديك مفاتيحُ كثيرة، لكنّ أحدهم دلَّك على المفتاح الصَّحيح ففتحتَ به الباب، فهل لأحدٍ أن يقول لك: أنتَ مخطئٌ ولم تفتح الباب حقيقةً؛ بل يجب عليك أن تجرِّب كل المفاتيح ثمَّ تفتح بهذا؟ ليس لعاقل أن يقول ذلك، وأنت أيّها المسلم قد وصلت، ألقى الله عنك وعَثاء التَّعب في البحث عن الطَّريق، فتمسَّك بدينك، ودع عنك هراءاتِ من يناديك إلى الانسلاخ من الدِّين لتختبرَ كُلَّ الطرق، فإنَّ هذا قول من حُرم الخير الذي حُزتَه، وضَلَّ عن الطريقِ الذي هديت إليه، وسار في طُرُقٍ ملتوية لا تورثُ يقينًا، ولا تجيبُ عن الأسئلة الوجودية، بل عاش في حيرةٍ واضطرابٍ وتخبّط، فوجب عليه أن يبحثَ عن الحقِّ الذي يتَّسق مع الفطرة والعقل، ويورثُ اليقينَ والطُّمأنينة، أمَّا أنت فقد وصلت إلى الحقّ الذي قد قامت عشراتُ الأدلة على صحَّته، فيكفيك الوصول، وأنَّك على الحق المبين، ثم ردِّد: ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوۡلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُۖ [الأعراف: ٤٣]، فاعرف الحقَّ وتمسَّك به، ثم استزد مَا شئت من أدلّته، وحِكَمه في تشريعاته، ونقص ما يخالفه، لتزدادَ يقينًا على يقينك، وإيمانًا فوق إيمانك.
بين الإسلام والاستسلام:
هذا الإسلام بكمالِ معبوده، وجمال تشريعاته، واتِّساقه مع العقل والفطرة؛ لن نلمس أثَرَه حتى نلتزم به أقوالا وأعمالًا، ونعيشه خلقًا وسلوكًا، فمن آمنَ الإنسانُ بأنَّ هذا الدِّين من عند الله وأنَّه الدين الحق، ينبغي له أن يحقِّق الاستسلام التَّام بهذا الدين وتشريعاته، فلا يأخذ ببعض أحكامه دون بعض، بل يأخذُ بكلِّ ما جاء به الإسلام، عقيدةً، وشريعةً، وخلقًا، وتعاملًا مع الآخرين، فالصلاح والفلاح كله في هذا الدين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.