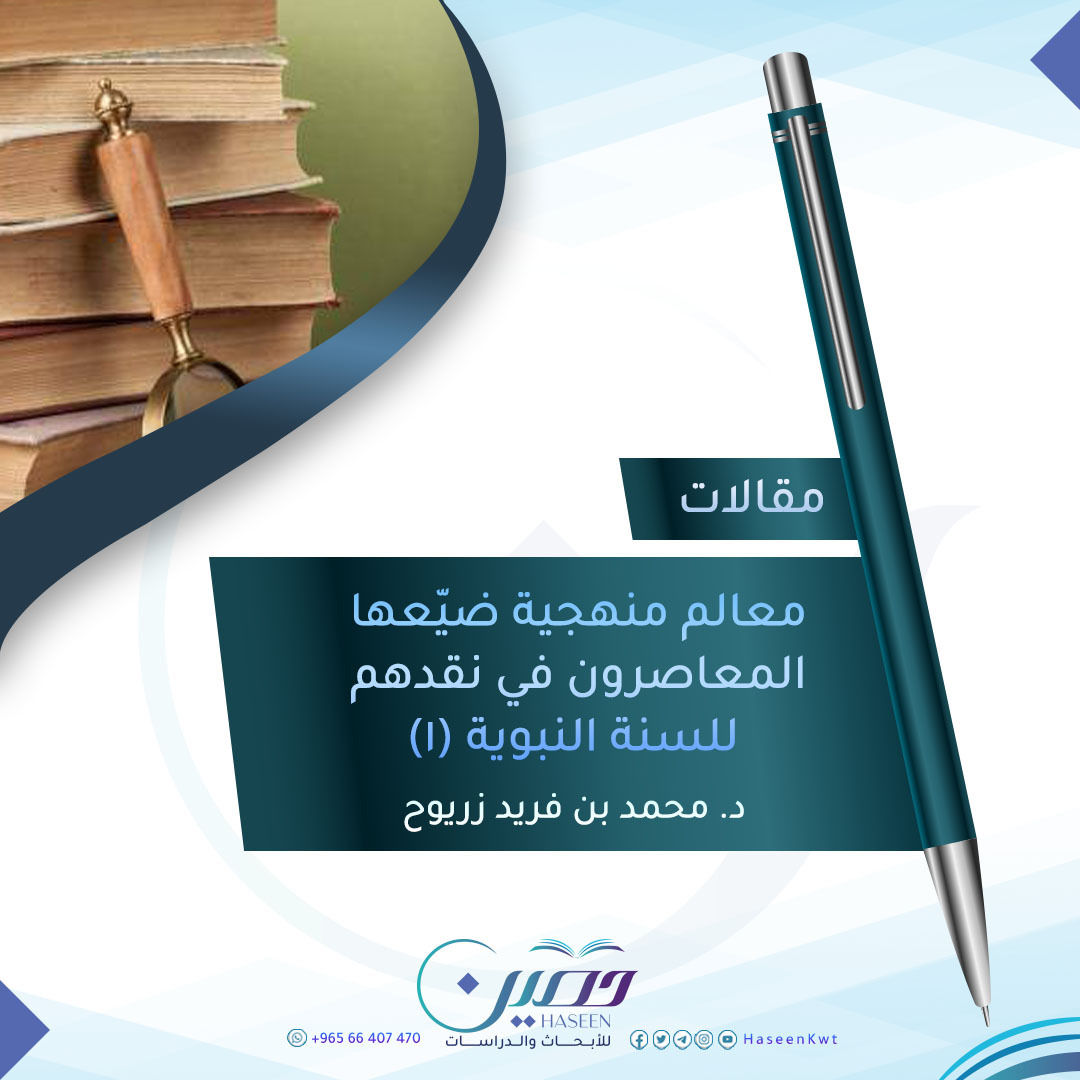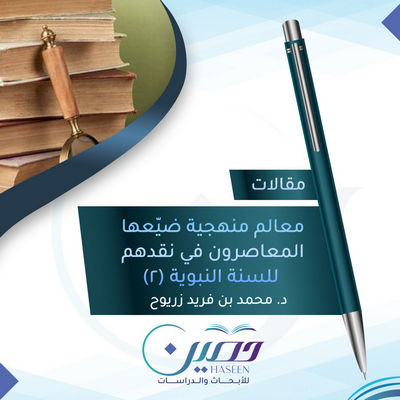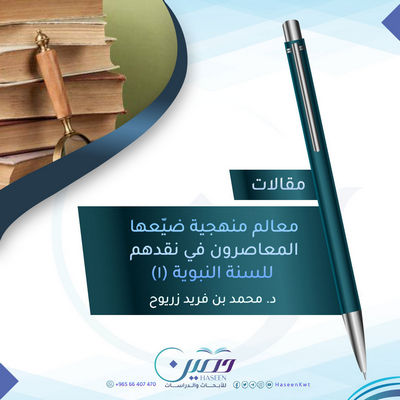بسم الله الرحمن الرحيم
كثيرًا ما يُساء توظيف آيات القرآن الكريم لمناقضة الأخبار النبوية؛ ذلك أنَّ الاتفاق حاصل من جميع الطَّوائف الإسلاميَّة على قُدسِيَّة القرآن وقَطعِيَّةِ نقلِه، وعُلوِّه حرفًا ومعنىً على كلِّ مَقالٍ، فكان منهم طوائف أنكرت أحاديث صحيحة عند أهل النَّقد، عارضوها بعُموماتٍ بعيدة فهموها من القرآن، وجَعَلوا هذا مسلكًا في ردِّ كلِّ حديثٍ خالَفَ أهوائهم ومرتكزات مذهبهم.
والمتَقرِّر من مذهب أهل السُّنة:
أنَّ الحديث إذا تَلَقَّاه العلماء بالقَبول ـ والأمَّة تَبَع لهم ـ كان مِن أشدِّ الأمورِ امتناعًا أن يُعارِض القرآنَ، بل «ليس يَسوغُ عند جماعةِ أهلِ العلمِ – كما قرَّره الحافظ ابن عبد البرِّ (ت٤٦٢هـ)- الاعتراضُ على السُّنَنِ بظاهرِ القرآنِ إذا كان لها مخرجٌ ووَجهٌ صحيحٌ، لأنَّ السُّنةَ مُبيِّنة للقرآنِ، قاضيةٌ عليه، غير مُدافعة له» ((التمهيد)) لابن عبد البر (١٧/٢٧٦). (١).
ومِن ثمَّ كانت المُقابلة بين الآيات والأحاديث مَسلكًا وَعِرًا في نفسه، يُحذِّر الوَرِع مِن الولوغ فيه، فما كلُّ النَّاسِ قادر على هذه المقابلة فيعرِفَ ما وافَقَه منها ممَّا خالَفه؛ إنَّما ذلك إلى الفقهاءِ العُلماءِ النُّقادِ للأخبار، العارِفين بطُرقها ومَخارجها؛ كما نَعتهم به الدَّارمي (ت٢٨٠هـ) ((نقض الدَّارمي على المرِّيسي)) (٢/٦٠٢). (٢).
هذا؛ والغلط في دركِ معاني الآيات وتوظيفها في غير مُراداتها بما يرجع على الشَّريعة بالتَّناقض قديم، قد تصدَّى له النَّاهلون من معين سُنَّةِ النبيّ ﷺ وسِيرَتِه؛ تراه -مثلًا- من حالِ أبي بكر حين خطب يومًا بالنَّاس فقال:
«يا أيَّها النَّاس، إنَّكم تَقرَؤون هذه الآيةَ وتَضَعونها على غيرِ مَواِضعها: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ [المائدة: ١٠٥]، وإنَّا سمِعنا النَّبي ﷺ يقول: «إنَّ النَّاس إذا رَأوا الظِّالم، فلم يأخذوا على يَديه، أوشَكَ أن يَعمَّهُم الله بعقابٍ» أخرجه أبو داود في سننه (رقم: ٤٣٣٨)، والترمذي في جامعه (رقم: ٢١٦٨)، وابن ماجه في سننه (رقم: ٤٠٠٥). (٣).
ولأنَّ السُّنَن الصِّحاح على حالٍ مِن التَّوافق مع القرآنِ، كونهما من مشكاة واحدة؛ ما كان للبَيانِ فيهما ـوهي السُّنةـ أن يُناقِضَ المُبيَّن، ولا للفرعِ أن يُعارضَ الأصل، والمُوحِي بهما ـ تعالى ـ يقول: وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ [النحل: ٤٤]: نجِد اللَّاهِجين بدَعوى المناقضة متخبِّطين في حملِ الآياتِ على مَحامِل متباينة، لا تستقيم على وزانٍ مُنتظِم، فلا نراهم يُبرِزون ضابِطًا مَوضوعيًّا دقيقًا للمُخالفةِ القرآنيَّة.
وعليهم صدقت كلماتُ ابنِ القَيِّم (ت٧٥١هـ) حيث قال:
«لو ساغَ رَدُّ سُنَنِ رسول الله ﷺ لمِا فَهِمَه الرَّجلُ مِن ظاهرِ الكتابِ، لرُدَّت بذلك أكثرُ السُّنَن وبَطَلت بالكُليَّة؛ فما مِن أحدٍ يُحتَجُّ عليه بسُنَّة صحيحةٍ تخالف مذهبَه ونِحلتَه، إلاَّ ويُمكنه أن يَتشبَّث بعمومِ آيةٍ أو إطلاقِها، ويقول: هذه السُّنَّة مُخالفةٌ لهذا العمومِ والإطلاقِ فلا تُقبَل!
حتَّى إنَّ الصّفويّة سَلَكوا هذا المسْلكَ بعَيْنِه في رَدِّ السُّنَنِ الثَّابتةِ المُتواترةِ، فرَدُّوا قوله ﷺ: «لا نورَث، ما تركنا صَدقةٌ» أخرجه البخاري في صحيحه (رقم: ٣٠٩٢) ومسلم في صحيحه (برقم: ١٧٥٩). (٤)، وقالوا: هذا حديث يُخالف كتابَ الله، قال تعالى: يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النساء: ١١]!
ورَدَّت الجهميَّة ما شاء الله مِن الأحاديثِ الصَّحيحةِ في إثباتِ الصِّفاتِ بظاهرِ قولِه: لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ [الشورى: ١١].
ورَدَّت الخوارج ما شاء الله مِن الأحاديثِ الدَّالةِ على الشَّفاعةِ، وخروجِ أهل الكبائرِ مِن المُوحِّدين مِن النَّار، بما فهِموه مِن ظاهرِ القرآن.
ورَدَّت الجهميَّة أحاديثَ الرُّؤيةِ -مع كثرتِها وصِحَّتِها- بما فهِموه مِن ظاهرِ القرآن، في قولِه تعالى: لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ [الأنعام: ١٠٣]» ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص/٦٦). (٥) .
ولنضرب مَثلاً على هذا الخلل المنهجيِّ في المقابلة بين الدَّلائل الشَّرعيَّة، ببابٍ من الحديث نبويٍّ أنكره بعض المُعاصِرين بدعوى مناقضته لمعنى القرآن:
فقد زعم أقوامٌ بُطلانَ كلِّ ما ورد من إتيانِه ﷺ ببعض الآياتِ الحِسيَّةِ، كانشقاقِ القَمر، وجَريانِ الماء مِن بين أصابِعه الشَّريفة، بحجَّة أنَّ القرآن قد قصر مُعجزاته على القرآنِ وحدَه، فليس مِن اختصاصِه ﷺ الإتيانُ بآياتٍ خارقةٍ للعادةِ.
يقول (محمد عابد الجابريِّ): «نحنُ نُؤكِّد -فعلًا- أنَّ الشَّيء الوحيدَ الَّذي يُفْهَم مِن القُرآن بأكملِه أنَّه معجزةٌ خاصَّةٌ بالنَّبي محمَّد ﷺ: هو القرآن لا غير، فالقُرآن يَكفي ذاته بذاتِه في هذا الشَّأن» ((مدخل إلى القرآن الكريم)) لمحمد الجابري (ص/١٨٧). (٦).
ثمَّ استدلَّ بقولِ الله تعالى: وَقَالُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ ءَايَٰتٞ مِّن رَّبِّهِۦۚ قُلۡ إِنَّمَا ٱلۡأٓيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٞ مُّبِينٌ ٥٠ أَوَلَمۡ يَكۡفِهِمۡ أَنَّآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ يُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحۡمَةٗ وَذِكۡرَىٰ لِقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ [العنكبوت: ٥٠-٥١].
وليس في هذا الاستدلال على نفيِ الآياتِ الحِسيَّة مُستمسَكٌ من القرآن، وذلك:
أنَّ الإغلاقَ واقعٌ في الآيةِ إجابةً لأهلِ مكَّةَ فيما اقترحوه مِن آياتٍ بعينِها لا في مُطلقِ الآياتِ! فإنَّ التَّكذيب بعد وقوعِ الخارقِ المَطلوبِ يوجِبُ هلاكَ المُكذِّبين بنصِّ القرآن نفسِه: وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ [الإسراء: ٥٩]، فلذا لم يُجِبهُم الله إلى طَلبِهم تلك الآياتِ بأعيانِها، رحمةً منه بقَومِ نبيِّه ﷺ وإمهالًا لهم.
فعلى هذا، تكون (الـ) التَّعريفِ في قوله تعالى: (الآيَاتِ): عَهْدِيَّةً.
وأمَّا حصولُ الكفايةِ بالقرآن فحَقٌّ لا نُمارِي فيه، كيف وهي آيته الكُبرى ﷺ؟! لكنَّها لا تستلزم نفي ما عداها مِن آيات حِسيَّة أجراها الله على يدي نبيِّه تثبيتاً لنُبوَّته في القلوب؛
إنَّما مَثل الآية: كرجل قرَّب لضيفٍ مائدةً بها أصنافٌ من الطَّعام، فلمَّا عاد إلى ضيفه، وجده على حالِه من الجوعِ لم يمسَّ طعامًا، فقال له: (لو أكلتَ طبق اللَّحم هذا لكان يكفيك!)، وهذا لا ينفي أنَّه وضع له أصنافًا أخرى من الطَّعام!
هذا؛ والأحاديث الدَّالة على آياته الحسيَّة متواترة عنه ﷺ في الجُملةِ! ترى المعترضَ عليها لم يدرك مرتبتها من حيث النَّقل: هل هي صحيحة تفيد العلم في مجملها، أم فيها نظر؛
ولا نظرَ في مرتبة الآية من حيث الدَّلالة: هل هي قطعيَّة أم ظنيَّة محتملة لمعانٍ،
وهذا ما عسَّر عليه طريق الجمع بينهما، وهو سهل مُتيسِّر كما رأيتَ.
هذا الخطأ المنهجيُّ نفسه: هو ما أوقع الشَّيخَ (محمَّدًا الغزالي) في إنكار بعض الأخبار النَّبويَّة المتَّفق علىها، كتشنيعه على أهلِ الحديثِ روايَتهم لحديثِ سِحْرِ لَبيدِ اليهوديِّ للنَّبي ﷺ مع كونِه مُتَّفقًا على صِحَّتِه أخرجه البخاري (رقم: ٥٧٦٦) ومسلم (رقم: ٢١٨٩). (٧) ، حيث قال: «إذا صَحَّ هذا، فلِمَ لا يَصِحُّ قولُ المُشركين: وَقَالَ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلٗا مَّسۡحُورًا [الفرقان: ٨] ؟!» ((الإسلام والطاقات المعطلة)) (ص/٥٤). (٨).
ومَعلوم أنَّ المَنزع القُرآنيَّ لهذه الشُّبهةِ اعتزاليٌّ قديمٌ، لا يَكاد يخلو منه كلامُ مَن رَدَّ الحديثَ مِن الأقدَمِين، وتوارَثه المُنكِرون المُتأخِّرون كـ (محمَّد عبده) الَّذي احتجَّ بالآيةَ ليرُدَّ على بعضِ الأزاهرةِ الَّذين أنكروا عليه ذلك ((مجلة المنار)) (٣٣/٤١-٤٣). (٩).
والآية على غير ما أرَادا، فإنَّ المشركين إنَّما ابتغوا بقولهم: (رَجُلٗا مَّسۡحُورًا): أنَّ أمرَ النُّبوة كلُّه سِحْرٌ، وأنَّ ذلك ناشِئٌ عن أنَّ الشَّياطين استَولوا عليه ـ بزَعمِهم ـ يُلقون إليه القرآن، ويَأمرونَه، ويُفهِمونه، فيُصدِّقهم في ذلك كلِّه، ظانًّا أنَّه إنَّما يَتَلقَّى مِن الله ومَلائكتِه، في حين «أنه رجل أصابه خلل العقل، فهو يقول ما لا يقول مثله العقلاء» ((التحرير والتنوير)) (١٨/٣٢٩). (١٠).
ولا ريبَ أنَّ الحال الَّتي ذُكِر في الحديثِ عُروضُها له ﷺ لفترةٍ خاصَّةٍ، ليست هي هذه الَّتي زَعَمَها المُشركون، ولا هي مِن قِبَلِها في شيءٍ مِن الأوصافِ المَذكورة ((الأنوار الكاشفة)) (ص/٢٥٢). (١١).
وبه تتبيَّن غلطَ بعض المنسوبين إلى العلمِ، حين تعجَّلوا ردَّ أحاديث عديدةٍ تتابع المختصُّون على تصحيحها والعمل بها، بدعوى معارضتها لما انقدح في أذهانهم من ظواهر بعض الآي، ليفتحوا بذا بابًا واسِعًا للمُتطفِّلين على السُّنة أن يعبَثوا في نصوصها نفيًا وإثباتًا؛ حتَّى رأينا منهم مَن طالب «باستبعادِ ألفَيْن إلى ثلاثةِ آلافِ حديثٍ -نِصفُها على الأقل ممَّا جاءَ في الصَّحيحين- لأنَّها تَتَعارض مع القرآن» أعني به جمال البنَّا في كتابه ((السنة النبوية ودورها في الفقه الجديد)) (ص/٢٦٥). (١٢)!
نعم؛ ردُّ حديثٍ لمدافعة القرآنِ له ليس مسلكًا بِدْعيًّا في ذاتِه، بل مهيعٌ مسلوك عند العلماء إذا تحقَّق مُوجِبُه، إذ «الأصل المَعلوم بالكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ لا يُعارِضُه خبرٌ واحدٌ رواه الثِّقات، بل يُنسَبون في ذلك إلى الغَلط» ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٢/١٠٤). (١٣)، ولا يَلزَمُ مِن تخبُّطِ مَن استعمله أنْ يكون باطلًا في نفسِ الأمرِ.
وإنَّما الشَّأن في تَحقُّقِ هذه المُخالفةِ بين آيةٍ وحديث صحيح في ظاهر سنده، بأن:
- يكون المعنى الَّذي نَسَبه المُعترِضُ للآيةِ هو معناها الصّريحُ القطعيّ مِن غير تَكلُّفٍ.
- وكان مَسبوقًا في هذا التَّفسير مِن أهلِ الذِّكر العالِمين به.
- مع تعسُّر الجمع لدَرءِ ما يَظهَر مِن تَعارضٍ.
- ولم يكُن للآيةِ وجهٌ مُعتَبرٌ آخرُ يُوافق الحديثَ عند ثلَّةٍ من أهلِ العلم.
فأمَّا أن تُحمَل الآيات على معنى لا يوائم سائر النُّصوص خِلاف الظَّاهر منها، ويُجرى بها على غير طريقة الأسلاف وما أُثر عنهم في تأويلها: فهذا أصلُ الخَلَلِ في هذا الباب، بصائرُ قد صاغها العلَّامة محمد الحجويُّ (ت١٣٧٦هـ) في أصيل قوله:
«قول النَّاقلِ عن الشَّيخ عبدُه: أنَّ العلماء اتَّفقوا على أنَّ الحديث إذا خالَف القرآنَ يُنبَذ، فهذا الكلامُ اتَّفَق كلُّ مَن نقلَه على أنَّه مُقيَّد، وليس على إطلاقِه، فقد زادوا شَرطين:
الأوَّل: أن تكون الآية صريحةً قطعيَّةَ الدَّلالة، والحديث ليس بمُتواتر، بل خبر آحاد مَظنونٌ، فتُقدَّم الآية عليها لأنَّها قطعيَّةٌ من جهة تواترها، وجِهة دلالتها القطعيَّة.
الثَّاني: أن لا يُمكن الجمع بين القرآن والسُّنة، أمَّا إذا أمكنَ الجمع بينهما، فإنَّه لا يحلُّ لأحدٍ أن يدَّعي التَّعارض، ويعرض عن سُنَّة المُصطفى ﷺ» ((الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام)) لمحمد بن الحسن الحجوي (ص/١٠٩). (١٤).
فهذا معلم منهجيٌّ ركيز في معارضة الأحاديث بكتاب الله تعالى، زلَّت فيه أقلامُ كثيرة في نقدها لمتون السُّنة النَّبوية، وسيأتي الكلام على معالم منهجيَّة أخرى أغفلها مُعاصرون في موقفهم من بعض الأخبار الشَّرعيَّة، في سلسلة مقالات تُنشر تِباعًا بإذن الله تعالى.
كفانا الله شرَّ الإنكار من غير إبصار، وألهمنا فهمَ وَحْيِه من غير إعثار، آمين.