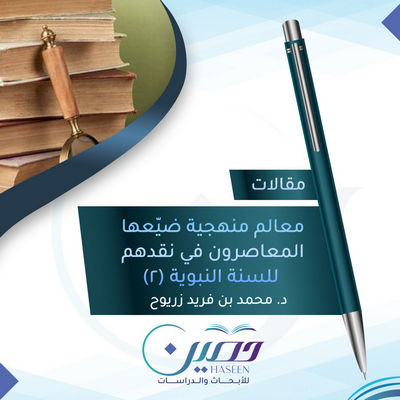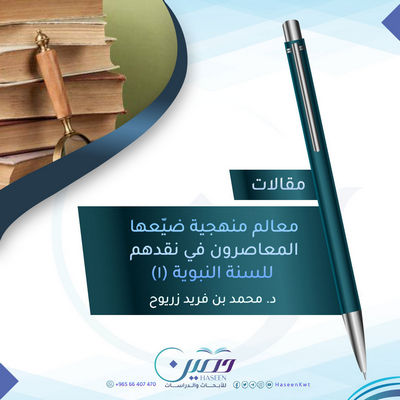بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وآله، وبعد:
لم يخلُ كلام الله جل جلاله - وهو أحكمُ الحاكمين، وكلامُه أحسن الكلامِ أجمعين - ولا كلام رسولِه ﷺ - وهو أفصحُ النَّاس وأنصَحُهم للنَّاس - مِن بعضِ مُتشابهٍ يختلِفُ النَّاس في دركِه، فتنةً تَصْغى إليها أفئدة الَّذين في قلوبهم مَرض، وفُسحةً مِن الاجتهادِ والتَّحرِّي يَنعمُ بأجرها عبادُه المُخلَصون؛ تتفاوَت به درجاتُهم في سُلَّم العلوم، ليختلف النَّاس حِيالها بين مُصيبٍ ومخطئٍ، ومُجتهدٍ ومُقلِّدٍ، ومُتأنٍّ ومُتهوِّرٍ، ومَأجورٍ ومَوْزور.
يقول ابن القصَّار المالكيُّ (ت٣٩٨هـ): «اِعلم أنَّ للعلومِ طُرقًا، منها جَليٌّ وخَفيٌّ، وذلك أن الله -تَبارك وتعالى- لمَّا أرادَ أن يمتحِنَ عبادَه وأنْ يبتليَهم، فرَّق بين طُرقِ العِلم، وجعل منها ظاهِرًا جَليًّا، وباطنًا خفيًّا، ليرفع الَّذين أوتوا العلم، كما قال عز وجل: يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ [المجادلة: ١١] «مقدمة في أصول الفقه» لابن القصار (ص/٥) (١) .
وحيث إنَّ النَّاسَ مُتفاوتون في معارفهم وإدراكاتهم وغاياتِهم، مُتباينون في امتِثالِهم لأحكام الشَّرع، فكان مِنهم راسخون في العِلم ذابُّون عن حياض الوحي، ومِنهم أهلُ زَيغٍ صبغوا دينَهم بألوانٍ من الهوى؛ فإنَّا بالتَّبصُّرِ في هذا الافتراقِ نُدرِك الحكمةَ الكبرى مِن وجودِ هذه المُشكلاتِ في النُّصوصِ الشَّرعيةِ: إنَّه تَمحيصُ ما في القلوبِ مِن اليقينِ والتَّسليمِ لله ورسولِه، وابتلاءُ العقولِ لتستفرِغَ الوُسعَ في التَّوَصُّل إلى مُراداتِ الله تعالى.
يقول أبو إسحاق الشَّاطبي (ت٧٩٠هـ): «مَسألة المُتشابهاتِ لا يَصِحُّ أن يُدَّعى فيها أنَّها مَوضوعةٌ في الشَّريعة، قصدَ الاختلافِ شَرعًا.. بل وَضعها للابتلاءِ؛ فيعملُ الرَّاسخون على وفقِ ما أخبرَ الله تعالى عنهم، ويَقع الزَّائغون في اتِّباعِ أهوائِهم» «الموافقات» للشَّاطبي (٦٩-٧١) (٢).
وقد اقتَضَت حِكمةُ الشَّارعِ ونصحُه ألَّا يوجَد في نصوصِه ما لا يُمكِن لأحدٍ مِن الأمَّة مَعرفة مَعناه، فإنَّ الدَّلائل الكثيرة توجِب القطعَ ببُطلانِ هذا، حتَّى ما تَعَلَّق منها بالغَيْبيَّاتِ، كنصوصِ الصِّفات وعوالم البرزخِ وما بعده ممَّا يعجزُ العقلُ عن إدراكِه، إنَّما يُجهَل منها كَيفيَّاتها وحقائقها، لا نفس معانيها، إذْ يبعُد «أن يخاطِبَ الله تعالى عبادَه بما لا سبيلَ لأحدٍ مِن الخلقِ إلى معرفتِه، بل يستحيلُ أن يتكلَّم بما لا يُفيد» «المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي (١٦/٢١٨) بتصرف يسير (٣).
وإنَّما استشكال النُّصوصِ الشرعية أمرٌ نِسبيٌّ إضافيٌّ، قد تشتبِه أفرادُها على بعضِ النَّاسِ دون بعضٍ، يُشكِلُ على هذا ما يعرفه ذاك، بحسبِ تنوُّع مَدارِكِهم، وتفاوت أفهامِهم، وتقابل آرائِهم انظر: «جامع أحكام القرآن» للقرطبي (٤/١٠-١١)، و«فتح الباري» لابن حجر (٨/٢١٠-٢١١) (٤)، فمَن خَفِيَ عليه المَعنى المُراد من نصٍّ كان مُتشابهًا ومُشكِلًا عنده، ومَن عَلِمَ المُرادَ منه زالَ عنه الإشكالُ وانتفى التَّشابه، وكان مُحكمًا عنده.
ومِن كمالِ أهلِ السُّنة في تعاملهم مع هذه الإشكالاتِ المَعنويَّة على النُّصوص الشَّرعيَّة، تأصيلهم لأصول ينطلقون منها في النَّظر إلى تلك المُتشابهات، وقواعدَ لدَرْءِ التَّخالفِ بين دلالاتها، ليُبقوا على مَنابعِ الأدلَّةِ السُّنيَّةِ صافيةً غيرَ آسِنة، لا تُكدِّرها دِلاء شُبهةٍ أو اضطرابٍ.
ومدلولات السُّنة النَّبويَّة أكثر ما يُفوَّق إليه سهام الإشكالات من مصادر التَّشريع في عصرنا الحاضر، وقد بادر علماء الأمَّة قديمًا إلى رفع أيِّ التباس عن صحَّة مَخابِرها، وتقرير موافقتها للأصول والمَعقول، منهم الشَّافعي (ت٢٠٤هـ) في "اختلاف الحديث"، وابن قتيبة (ت٢٧٦هـ) في "تأويل مختلف الحديث"، والطحاوي (ت٣٢١هـ) في "شرح مشكل الآثار"، في آخرين بعدهم.
وفي هذا المقال الوجيز بعضٌ من مَعالم منهجيّة يسترشد بها النَّاظر فيما أشكل عليه من الأخبار النَّبويَّة، استخلصتها من مجموع قراءاتي لنتاج أفكارهم في هذا الباب من خلال ما صنَّفوه حلًّا لمُشكلات الأخبار استقلالًا، أو كان عرضًا في مصنَّفات لهم في مواضيع أخرى أعمَّ ككُتب الشُّروح الحديثيَّة.
فكان من أحقِّ هذه المعالم بالتَّقديم لتفرُّع ما بعده عنه هو:
المَعلم الأوَّل: الاعتقادُ المَبدئيُّ بانتفاء التَّخالف بين دلائل الشَّرع والعقل.
فإنَّ من مقتضيات إيمان المرء بدينه اعتقاده ألَّا تَضَادَّ بين آياتِ القرآن، ولا بين الأخبار النَّبويَّة، ولا بين أحدِهما مع الآخر، ولا بين هذه الأدلَّة الشَّرعية وحقائق الواقع، فإنَّ الجميع - بعبارة الشَّاطبي «الاعتصام» للشاطبي (ص/٨٢٢) (٥)- جارٍ على مَهيعٍ واحدٍ، فإن أدَّاه بادئُ الرَّأي إلى ظاهرِ اختلافٍ، فواجبٌ عليه أن يعتقد انتفاءَ الاختلافِ، لأنَّ الله قد شهِدَ له أن لا اختلاف فيه.
ولذا عدُّوا استصحابَ النَّاظر في النُّصوص لهذا الأصل من التَّوافق بين صِحاح الأخبار وسائر براهين الشَّرع والعقل أمارةً على حسن تسليمِه للوحي، فإنَّ المتتبِّع لأحوال الوالغين في السُّنَن لمزًا وتسفيهًا، يجد مِنهم خَلقًا كثيرًا في قلوبهم رَيْبٌ في نفسِ الإيمانِ بالرِّسالة، وفيهم مَن في قلبِه ريبٌ في كونِ الرَّسولِ أخبَرَ بهذا انظر هذا المعنى في «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (٦/٥) (٦).
وأمَّا المَعلم الثَّاني فهو: الاستِشكالُ لا يَستلزِمُ البُطلان.
إنَّ التَّسارع في الإبطالِ للنَّقليَّات لمجرَّد استشكال دلالتها من أوسع أبواب الباطل، فإنَّ استشكالِ نصٍ لا يعني بُطلانه ضرورةً؛ إذ الواحد منَّا كثيرًا ما يُؤتى من قِبل رأيه واجتهادِه، تمامًا كما يحصُل أن يستشكل أحدنا آية من كتاب الله تعالى من غير أن يدعوه ذلك أنْ يرتاب فيها، على أنَّ الخَلَل في دعوى البُطلان من حيث ما نراه في الوجود أكثر مِن الخَلل في نقل الأحاديثِ الَّتي تلقَّتها الأئمَّة بالقبول.
يقول المعلِّمي (ت١٣٨٦هـ): «لا نزاعَ أنَّ النَّبي ﷺ لا يُخبر عن ربِّه وغَيْبِه بباطلٍ، فإن رُوي عنه خَبرٌ تقوم الحجَّة على بُطلانه فالخَلل مِن الرِّواية، لكنَّ الشَّأن كلَّ الشَّأن في الحكمِ بالبُطلان! فقد كثُرَ اختلافُ الآراءِ، والأهواءِ، والنَّظرياتِ، وكَثُر غلطها، ومَن تَدبَّرها وتَدبَّر الرِّوايةَ وأمعنَ فيها، وهو ممَّن رَزَقه الله تعالى الإخلاصَ للحقِّ والتثبُّت: عَلِم أنَّ احتمالَ خطأِ الرِّوايةِ الَّتي يُثبتها المُحقِّقون مِن أئمَّة الحديث، أقلُّ جدًّا مِن احتمالِ الخطأِ في الرَّأيِ والنَّظر» «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/٢٣٦-٢٣٧) (٧).
إنَّ أهل السُّنة إذْ يَدعون إلى التروِّي عند استشكال نصوص الشَّرع، لا ينفون جواز الحيرةِ في دَركِ ما دلَّت عليه بعضِ الأخبار النَّبويَّة، إنَّما الَّذي يَأْبَوْنه التَّسارع في ترتيب الإبطالِ لتلك الدَّلائل على انقداحِ الاستشكال.
والدَّيِّن الكَيِّس إذا استصعَبَ عليه جواب إشكالٍ في نصٍّ شرعيٍّ لاذَ بمَن فوقه عِلمًا وفَهمًا، فرَدَّ المُشكِل منه إلى أهلِه، ليتَّضح له المنهج، ويتَّسِع له المَخرج، متأوِّلًا في ذلك قولَ ربِّه: فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ [النحل: ٤٣]، وقولَه تعالى:
وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ
[النساء: ٨٣]، فَرَقًا من أن يدخل في قوله تعالى: بَلۡ كَذَّبُواْ بِمَا لَمۡ يُحِيطُواْ بِعِلۡمِهِ [يونس: ٣٩].
غير أنَّ المُشاهَد مِن جِهة الواقعِ لِمن سَبَر أغوارَ النَّفسِ البشريَّة، وتكشَّفت له آفاتها عند الفِتَن: أنَّ المُحرِّك الحقيقيَّ لهذا التَّحوُّل العَجِل مِن استشكالِ النَّص إلى الكُفر به ليس الاستشكالَ في ذاته، ولكن الحالة المزاجيَّة الَّتي تعتري كثيراً من النَّاس أثناء استشكالِهم للأخبار، وما تنطوي عليه نفوسهم من نُفرةٍ عمَّا دلَّت عليه من أحكام.
فعلى المؤمن إذا أشكلَ عليه حديثٌ صَحَّحه الأئمَّة ولم تُطاوعه نفسُه على حملِ الخطأ على رأيِه ونظرِه، «أن يعلَمَ أنَّه إن لم يكُن الخلَل في رأيِه ونظرِه وفهمِه فهو في الرِّواية، وليفزَعْ إلى مَن يثق بدينِه وعلمِه وتقواه، مع الابتهال إلى الله عز وجل» «الأنوار الكاشفة» للمعلمي (ص/٢٣٧) (٨)، وليُقلِّب كُتب الشُّروح الحديثيَّة، فإنَّ كثيرًا منها يقف على مشكلات نصوصها، ويروي الغليل في حلِّها، فضلًا عن الكُتب المخصوصة في دفع المشكلات عن متون الأحاديث، ولو استطالَ به الزَّمَن في هذا البحث، فإنَّه لا يزال في طاعة.
فما أحرى هذا المَعْلم أن يُربَّى النَّاشئة عليه، فإنَّ الواحد من بني آدم قد يكون مِن أذكياءِ النَّاس وأحدِّهم نظرًا، ويُعمِيه ربُّه عن أظهر الأشياء، وقد يكون مِن أبْلَدِ النَّاس وأضعفِهم نظرًا، ويهديه لمِا اختُلف فيه مِن الحقِّ بإذنه.
فمَن اتَّكل على نَظَرِه واستدلالِه، أو عقِله ومَعرفتِه: خُذِل «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (٩/٣٤) (٩)، ومَن تبَرَّأ من حولِه وفهمِه إلى حولِ الله وهدايتِه: هُدي؛ فهو الرُّكن الشَّديد، ومَفزعُ الأئمَّة في المُلمَّات علمًا وعملًا.
وأمَّا المعلم الثالث: فالعَملُ بمُحكَماتِ النُّصوص وتحكيمُها في فقهِ الأحاديثِ المُشتبِهات.
اللَّازم على المُتَّبع الإيمانُ بنصوص الوَحْيين، والأخذ بما استبانَ له منها، وما اشتَبَه عليه وَكَل علمَه إلى ربه تعالى والعالِم به، فإنَّه ﷺ الصَّادِق في خبره، وأُمَّتَه لا تجتمع على تصديقِ كَذِبٍ عنه انظر هذا المعنى في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣/٤١) (١٠)، هذا منصوص أئمَّة السَّلَف بعامَّة انظر: «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (٣/٧) (١١)، مُسترشدين في ذلك بقولِه تعالى: وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ [آل عمران: ٧].
وفي قوله تعالى في الآية نفسِها: مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ [آل عمران: ٧]: حَقُّ المُحكَم في أن يُرَدَّ إليه المُشتبِه في بابِه، كما نردُّ المحتمِل إلى غير المُحتمِل، والعامَّ إلى الخاصِّ، والشَكَّ إلى اليقين، إذ الأقوى مُقدَّم عند التَّعارض أبَدًا، والمُحكم أقوى من المتشابه من جهة الدَّلالة، فكان بهذا «أصلًا تُرَدُّ إليه الفروع، والمُتشابه هو الفَرع»«جامع أحكام القرآن» للقرطبي (٤/١٠) (١٢).
وفي تقرير هذا الأصل من تفسير المُشتبه بالمُحكم يقول ابن القيِّم (ت: ٧٥١هـ): «طريقةُ الصَّحابة والتَّابعين وأئمَّة الحديث -كالشَّافعي، والإمام أحمد، ومالك، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، والبخاري، وإسحاق- هي أنَّهم يَردُّون المُتشابه إلى المُحكَم، ويأخذون مِن المُحكَم ما يُفسِّر لهم المُتشابه ويُبيِّنه لهم، فتَتَّفق دلالته مع دلالة المُحكمِ، وتوافق النُّصوص بعضُها بعضًا، ويُصدِّق بعضها بعضًا، فإنَّها كلُّها مِن عند الله، وما كان مِن عند الله فلا اختلافَ فيه ولا تَناقض، وإنمَّا الاختلافُ والتَّناقض فيما كان مِن عند غيرِه» «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢/٢١٠) (١٣).
ثمَّ المَعلم الرّابع: وهو التَّفتيش في الإسنادِ عن مُوجِب الخَلَل عند الرُّكون إلى فسادِ المتن.
فما استشكَله المسلمُ مِن معنى حديث صحيح النَّقل ظَنَّه مُعارضًا لأصلٍ ما، لا يجوز له رَدُّه هكذا حتَّى يستبين فسادَه كما قرَّرناه، ولينظر في نَقَلتِه مَن يحمل تَبِعة هذا الفساد، على منهج نقَّاد الحديث في تعليل أحكامهم، فإنَّهم كثيرًا ما رَدُّوا أحاديث بمُخالفةِ الأصولِ، وأناطوا علَّة ذلك في حلقة من حلقات أسانيدها.
يقول ابن عبد البرّ (ت٤٦٣هـ): «ليس أحَدٌ مِن علماء الأمَّة يُثبت حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يردُّه دون ادِّعاءِ نسخِ ذلك بأثرٍ مثلِه، أو بإجماعٍ، أو بعملٍ يجبُ على أصلِه الانقيادُ إليه، أو طعنٍ في سَندِه؛ ولو فَعَل ذلك أحدٌ سَقَطت عدالته، فضلًا عن أن يُتَّخَذ إمامًا، ولزمَه اسمُ الفسق»! «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (٢/١٠٨٠) (١٤)
ويَقول المُعلِّمي: «إذا استنكَرَ الأئمَّة المُحقَّقون المتْنَ وكان ظاهر السَّندِ الصِّحة: فإنَّهم يتطلَّبون له عِلَّة، فإذا لَم يجدوا عِلَّة قادحةً مُطلقًا حيث وَقَعت، أعلُّوه بعلَّةٍ ليست بقادحةٍ مُطلقًا، ولكنَّهم يرونَها كافيةً للقدحِ في ذاك المُنكر» مقدمة تحقيق المعلمي لـ «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص/٨) (١٥).
وبتقرير هذا المَعلمِ ينجلي أحد الفروق بين منهج المتقدِّمين مِن أهل السُّنة وكثيرٍ من المعاصرين في نقدِ الأحاديث: وهو أنَّ الأوائل إذا رَأوا حديثًا بيِّنَ الفسادِ مِن جِهة معناه، أعلُّوه بالإشارة إلى مكمن الخَلل في إسنادِه، أي: في طريقةِ تحمُّلِه ورِوايتِه؛ بينما لا يَرقى هذا الإسنادُ عند المُعاصرينَ إلى تلك الأهمِّية، ومِن ثَمَّ سَهُل عليهم الاقتصارُ على الطَّعنِ في الأحاديثِ مِن جِهة متونِها.
وحاصلُ القولِ في هذا البابِ من مُشكلات الأخبار وما يحصل من بعض النَّاس من إنكارها دون بيِّنة: ما أحكمَ ابن تيميَّة سبْكَه في كلماتٍ بليغات، جَمَعت بين متانةِ التَّقعيدِ العلميِّ، وروحِ التَّوجيه التَّربوي، يقول فيهنَّ: «التَّكذيب بما لم يُعلَم أنَّه كذب، مثل التَّصديق بما لا يُعلَم أنَّه صدق، والنَّفي بلا علم بالنَّفي، مثل الإثبات بلا علمٍ بالإثبات، وكلٌّ من هذين قولٌ بلا علم.
ومَن نَفى مضمونَ خبرٍ لم يَعلم أنَّه كذب، فهو مثل مَن أثبتَ مضمونَ خبرٍ لم يَعلَم أنَّه صدق، والواجبُ على الإنسان فيما لم يقُم فيه دليل أحد الطَّرفين، أن يُسرِّحَه إلى بُقعةِ الإمكان الذِّهني، إلى أن يحصل فيه مُرجِّح أو موجب، وإلَّا يكن قد سَكت عمَّا لم يعلم، فهو نصف العلم.
فرحم الله امرأً تكلَّم فغنم، أو سكَت فسلِم، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقُل خيرًا أو ليصمُت، وإذا أخطأ العالمُ لا أدري، أُصيبت مَقاتله» «جواب الاعتراضات المصرية» لابن تيمية (ص/٥٢) (١٦).
أعاذَ الله مَقاتِلنا أن تُصاب، وأفهامَنا أن تزيغَ عن الصَّواب؛ آمين.