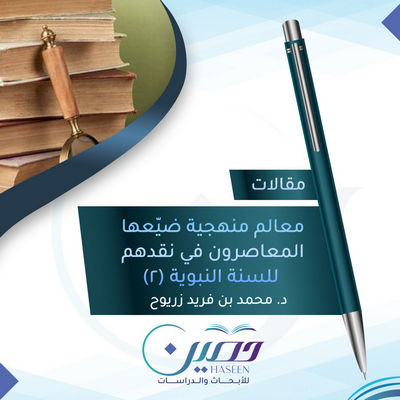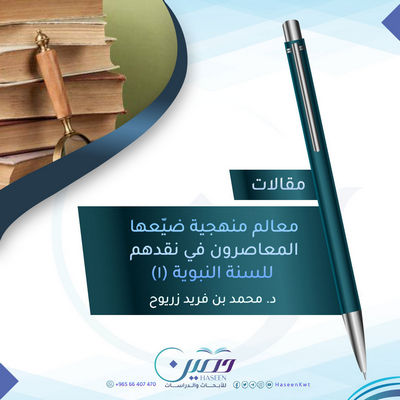بقلم: د. لؤي الصمادي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
منذ أهبط الله تعالى آدم عليه السلام إلى الأرض، وإبليس الذي أخرجه من الجنة متربّصٌ به، يبتغي إنفاذ وعده فيه بإغواء ذرّيته، وقد صدّق عليهم ظنّه، فاتّبعه الأكثرون وعصاه الأقلون.
ولإبليس في إضلال أتباعه سبلٌ شتّى، فمن النّاس من أوقعهم في عبادة الصالحين غلوًّا فيهم، ومنهم من فتنهم بعبادة الكواكب اعتقادًا لتأثيرها وتدبيرها، ومنهم من حرفَهم إلى عبادةِ الملائكة وادّعاء أنها بنات الله، ومنهم من أزاغ عقولهم إلى تثليث الربِّ سبحانه، ومنهم من ألقاهم في جُرُف الكفر بشرائع الله والاستكبار عن الخضوع لأمره.
ولم يبالِ إبليس إذا صرف أتباعه عن عبادة الله تعالى في أي أودية الهَلاك سقطوا؛ لأنّ مقصوده أن يوقع في صُدور العبادِ ِسُوءَ ظَنِّهم بربِّهم، ويصرفَ وجوههم عما خُلقوا لأجله من الإسلام لله وعبادته، فإمّا أن يكون ذلك بإعلان الامتناع عن الخضوع له، وإمّا أن يكون بالتولّي عن عبادته إلى عبادة غيره.
والغالب على الخلق في تاريخ البشرية سلوك المسلك الثاني، لظهوره غالبًا في مظهر ادّعاءِ شريكٍ لله في ذاته أو في بعض أفعال ربُوبيّته، أو في زعم وجود شفعاءَ ذوي زلفى لديه، يُنال المطلوب من الله بالتقرّب إليهم من دونه، وهو مسلكٌ أخفى في ردّ العبودية لله ورفض الدّينونة له من الأول، وأكثر تلبيسًا وتدليسًا، لأنّه يُبقي لله صورةَ تعظيمٍ مخادعة، بأن يبدو الشريك أدنى من الله، وإنّما يُشاركه في بعض خصائصه، وأمّا المسلك الأوّل – وهو إعلان الامتناع عن الخضوع لله - فهو واضحٌ في رفض العبودية للخالق العليم وجَحد حقّه، وفيه من الفجاجة والشَّناعة ما هو كافٍ في استقباحه والنُّفور منه، لكن قد يتضاءل الشعور بقبحه حين ينال العبد من الدّنيا ما يُنسيه عظمةَ ربّه، ويُشعره بالاستغناء والترفّع والطّغيان، كما قال تعالى: كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ٦ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ [العلق: ٦-٧]، وهذا كما حصل لنمرود وفرعون وأضرابهم، وكما حصل لصاحب الجنتين، بل هو مسلك إبليس الذي سلكه مع ربّه حين رفض طاعته صراحةً، إباءً واستعلاءً.
ولمّا كانت طبيعةُ الإنسان التي لا تختلف قديمًا وحديثًا ما وصفه الله به من أنه جهولٌ ظَلوم، وكانَ ما ابتلاه الله به في زماننا الذي نعيشُه اليوم، مِن تعليمه الكثيرَ من العلوم والاكتشافات، وبسط يدِه في الاختراعات والصناعات، أمرًا لم يسبق له مثيل، فقد صار هذا الزمانُ أكثرَ زمانٍ يشعر فيه هذا الإنسان بالاستغناء عن الله والطّغيان عن الخضوع له، وزادَ الأمرَ شدّةً وقوعُ ذلك مصاحِبًا لخروج القارّة العجوز من رِبقة دين الكنيسة الظالم، فصار حالها حالَ النصرانيّ الفقير الفاجر، الذي ملّ دينَه الفاسد وضاقَ به ذرعًا، فلم يزل ينحلُّ منه شيئًا فشيئًا، والدُّنيا تتسع له شيئًا فشيئًا، حتى كمُل له الغِنى مع تركه التديّن بالكلّية، فاجتمعت عليه دوافع الطغيان والاستكبار، وفي ذلكم بلاءٌ من ربّكم عظيم!
وهذا البلاءُ لم يخصّ أوروبّا وحدها، بل عمّ الأرض وطمّها، فاختارت أكثر البشريّة -إلا فريقًا من المؤمنين – ذلك المسلكَ الإبليسيّ الاستكباري، برفضها الأديانَ جملةً، لتعيش في حالةٍ من الأنَفةِ اللّادينيّة، حيث يكونُ الإنسان هو المتألِّهَ في نفسه، يرى أنّ له الحُكمَ والاختيار، لأنّه صاحِب العلوم والقُدُرات، والحُقوق والحرّيات، المستوجبُ بذلك كمالَ التعظيم والاحترام، فلا معقّب لرأيه، ولا مخطّئ لحكمه، فآراؤه - على اختلافها – صحيحةٌ، والحقيقةُ تتعدّد بتعدّد هذا الإنسان!
والله تعالى غنيّ كريم، لا يحتاجُ إلى عباده، ولا يعبَأُ بهم لولا دعاؤهم وعبوديّتهم، فإنه لم يخلقهم إلا لذلك، ولولا حِلمه وحكمته ورحمتُه ما ترك على ظهر الأرض من دابّة، لكنّه بحمدِه أرسلَ الرّسل إلى أقوامهم، يدعونهم إلى تحقيق العبودية له سبحانه، ويقيمون عليهم الحُجَج بحقِّ الله تعالى عليهم بالمحبَّة والتعظيم، والخَشيةِ والرَّجاء، لما له عليهم من النِّعَم والرُّبوبيّة، ولما هو عليه من كمال الحَمد والإلهيّة، فجعلوا ينهَون أهلَ المَسلَكِ الكُفريّ الشِّركيّ عن عبادةِ غير الله ويردُّونَهم إلى عبادة الله، وينهَون أهلَ المسلكِ الكُفريّ الاستكباريّ عن جعلهم أنفسَهم أندادًا لله، ويعالِجون غطرستهم بتذكيرهم بافتقارهم وعجزهم، وعبوديّتهم الاضطراريّة لله.
وإذا كان العلماء ورثةَ الأنبياء، فليست مُهمّتُهم سوى ما جاؤوا به؛ أن يقيموا الحجج على استحقاق الربّ سبحانه العبوديّة على خلقه، وذلك من خلال بيان العبودية ومقتضَياتها وموجِباتها، ودفع ما يمنعها ويحول دون تحقيقها.
فحقيقة العبودية لله تحقيق كمال الخضوع له اختيارًا، بناءً على ما يستحقّه من المحبّة والخوف والرّجاء، وهو معنىً يسري في جميع الأفعال التعبّدية، لأنّه لبّها وروحها ومادّة حياتها.
ومقتضى هذا الخضوع هو الطاعةُ المطلقة لله ورسوله ﷺ، وتحكيم أمره في الإيجاب والتحليل والتحريم، وتعظيمُ نصوص الوحي، والتسليمُ لأخبارها تصديقًا، ولأحكامها امتثالًا، دون اعتراضٍ بالأذواق والآراء، مع الرّضا بالإسلام دينًا والاعتزازِ والفرح به، والولاءِ والبراء عليه، ومتى ما تمّ ذلك للعبد، زالت عنه جميعُ الإشكالات والشُّبهات الجزئية، واستقام قلبه مؤمنًا مخلصًا، ومُذعنًا مُسلِّمًا.
وأعظم ما يوجِب هذه العبودية ويؤسّس في النّفس استحقاقَ الله تعالى لها، هو العلم بربوبيّته سبحانه وإنعامِه، والعلمُ بكمالاته ومحامده، مع ما تقتضيه صفاته من تشريع الشرائع، وإرسال الرّسل ببيانها، وتحديد يومٍ للحِساب والجزاء عليها.
ولا يتمّ للعبد ذلك إلّا بتصفية نفسه من موانع العبودية ومفسداتِها من الاستنكاف والاستعلاء، والشعورِ بالاستحقاق أو الاستغناء، وذلك بعلمه بنفسه وأوصافها، من جهةِ أصل خِلقته، ولزوم افتقاره ونقصه، وما لا ينفكّ عنه من العجز والجَهل والحاجةِ، وكونه مملوكًا مدبَّرًا داخرًا تحت حكم الله فيه، وأنّه لا شيءَ له ولا به إلا بالله خالقه، فإذا أدرك ذلك وتيقّن به، زالت عنه تلك الموانع، فسلم من معاندة العبودية لله وسوء الظنّ به، وأوجبت له معرفته بالله آثارَها التي هي أعظم أسباب سعادته وفلاحِه.
ولمّا كانت رسالةُ الإسلام الخاتِمة، هدايةً للخلق أجمعين، فقد تكفّل القرآنُ الكريم المنزَّل على نبيّنا محمد ﷺ ببيان هذا كلّه، فقرّره ببراهينه وحُجَجه الدامغة، بأساليبَ متنوّعة، تفضي بمن تأمله وتدبّره مستعدًّا لقبولِه، إلى صميم مطلوبه، ففيه -بحقٍّ- الكفايةُ والغُنية لتحقيق ذلك، والضّمانة الإلهيّة لمن اتّبعه بالسلامة من الانحرافات الموبقة في المهالك، كما قال سبحانه قولًا صادقًا مبينًا:فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ[طه: ١٢٣]، وقال ﷺ في حجة الوداع: «قد تركتُ فيكم ما لن تَضِلُّوا بعدَه إن اعتصمتم به: كتابُ الله». رواه مسلم (رقم ١٢١٨).
ففي القرآن ما هو الغاية في: بناءِ العُبودية وتفصيل حقائقها القلبيّة، وحشدِ موجِباتها القائمة على معرفةِ الله بالحمد والربوبية، ودفعِ موانعها بتذكير العباد بعبوديّتهم الاضطرارية، واستخراج ما يقع في قلوبهم من فساد النّوازع الإنسانية، وتفريعِ مقتضَياتها بتنبيه المؤمنين على ما يوجِبه إيمانُهم من الاستجابة لأوامره والرّضا بأحكامه الشّرعيّة.
وخِطابُ القُرآن لم يأتِ على عُرفٍ خاصٍّ بقومٍ أو على لغةٍ نُخبويّة، كما تجده في الأطروحات الفلسفية أو الكُتب التخصّصية، ولا جاءَ خَطابيًّا جُمهوريًّا يثير المشاعِر بلا برهان، بل جاءَ كلامًا محكمًا فَصلًا مبينًا، حِجاجيًّا ووُجدانيًّا، يقيم للعقول البراهين ويجادل المبطلين بأنواع الأدلة العقليّة، مؤثّرًا في النّفوس ومشعلًا فيها المعاني القلبيّة العمليّة، كلّ ذلك في آنٍ معًا، مع سهولةِ ألفاظه بأحسن ما يكون عليه اللِّسان العربي، وقُرب مفاهيمه ويُسرها على العقل الفطريّ.
فمتى ما رامَ الدّاعية علاجَ واقعه وانتزاعَ الباطل من جذوره في هذا الزّمان وكلِّ زمانٍ، فلن يجد أقوى من وحيِ الله تعالى مصباحًا يضيءُ به الظُّلمات، ولن يجد أمضى منه سلاحًا يحارب به الباطل، ولا أنفع منه دواءً يعالجُ به المرضى.
ومن الأخطاء التي تقع كثيرًا في السّجال الفكريّ القائم في زماننا اليوم مع الفكر اللادّيني، الغفلةُ عن إدراك تلك المضامين القرآنية وإحسانِ توظيفها وإصابة الداءِ بها.
كما أنّ الغفلة عن الطّرح القرآني أفضت بكثيرٍ من المشاريع البنائية والعلاجية إلى الإغراق في خطابٍ نُخبويّ، لا يلامس عقول أكثر العامّة من المسلمين أو المتشكّكين أو المخالفين، ولا يشبع جوعَة نفوسهم، مما يؤخّر مراحل الشّفاء، ويبقي المريض يتلوّى في حسرة وحَيرة، مع أنّ عسل الشفاء ماثلٌ بين يديه، فحاله:
كالعِيسِ في البيداء يقتلها الظَّما
والماءُ فوقَ ظهورها محمولُ!
ومن هنا جاءَت رسالة «مركز حصين للأبحاث والدّراسات» بالكويت، ترمي إلى المساهمة في التركيز على هذه الحلقات الثلاث، التي يمكن أن تتشابك فيما بينها مؤلِّفةً سِلسلة نَجاةٍ بإذن الله، ألا وهي: تقريرُ العبودية لله تعالى، بالاعتمادُ على الخطاب القرآني وأسلوبِه بما فيه من كفايةٍ ووَفاءٍ برهانيٍّ وجدانيّ، وإيصالِه إلى عموم المخاطَبين بالدّعوة، بحيث تُقتفى طريقةُ الرّسل عليهم السلام في الإصلاح، والتي هي إيصالُ عموم الخلق إلى ربّهم، بإبلاغ آياتِه ودلائله البرهانيّة المؤثّرةِ إليهم، للوصول بهم إلى مراده، وهو تحقيق عبادته.
فإن يكن لهذا المركزِ من نجاح مقصدٍ وبلوغِ مَرام، فهو بحول الله تعالى وقوّته وتوفيقه وفضله، وإلّا فشأنُ المخلوقين النقصُ والعَجْز، إذ ليس لهم من دون تسديدِ الله إتمامٌ ونَجْز، فعلى الله التُّكلان، وهو وحده المُستعان، لا ربّ غيره، ولا إلهَ سواه، والحمد لله ربّ العالمين.